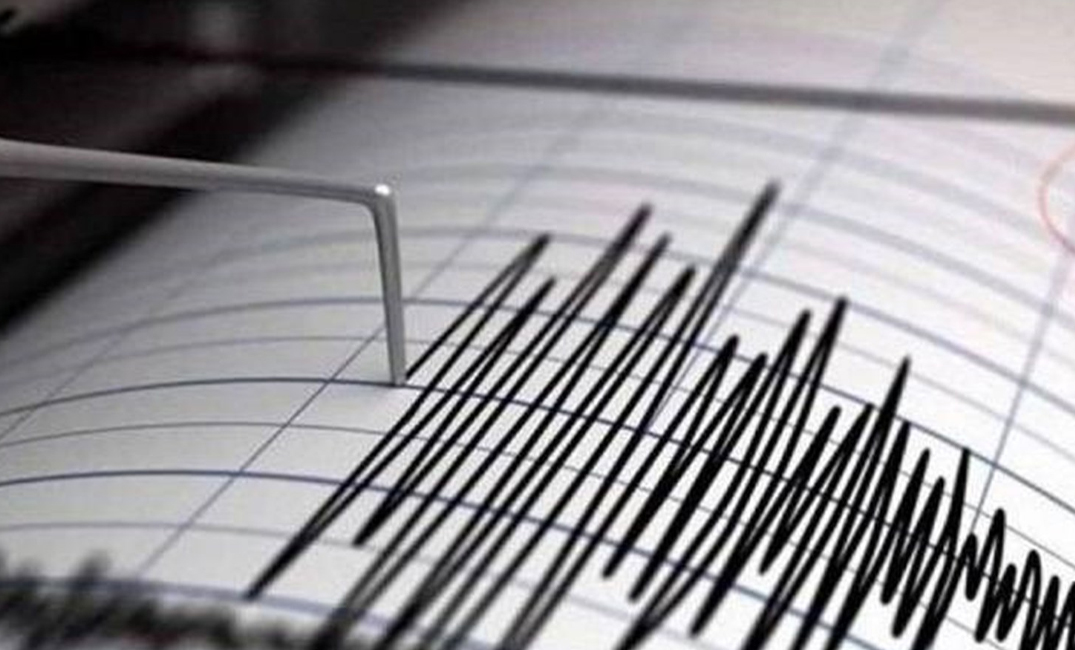فتحي المسكيني *
في سنة 1807، في أحد فصول كتاب فينومينولوجيا الروح، أشار هيغل إلى أنّ الثورة الفرنسية وهي تضع مفهوم “الحرية المطلقة” موضع التنفيذ – ما بين 1792 و1794 إبّان استعمال “الإرهاب” (la Terreur) أداةً إجرائيةً بحتة من أجل تصفية نسقيّة لكلّ “أعداء الثورة” أو “أنصار الثورة المضادة” – قد دشّنت مفهومًا جديدًا عن الموت: إنّه “الموت بلا معنى” (der bedeutungslose Tod) أو “بلا دلالة”، الذي تنحصر صلاحيته أو وجاهته في “الإرهاب المحض للسالب (der reine Schrecken des Negativen)، الذي ليس فيه أيّ شيء موجب أو متحقّق” بحيث أنّ “العمل الوحيد والفعل الوحيد للحرية الكلّية هو بذلك الموت، وعلى الحقيقة موتٌ، ليس له أيّ حجم ولا تحقّق داخلي؛ وذلك أنّ ما تمّ سلبُه، إنّما هو النقطة غير المتحقّقة من الذات الحرّة بإطلاق؛ إنّه إذن الموت البارد والسطحيّ كأشدّ ما يكون، الذي ليس له دلالة أكثر من اختراق رأس كُرنب أو من رشفة ماء.”
هذا الربط في ماهية الموت، منذ تدشين عصر التنوير، بين “اللامعنى” و”الإرهاب” هو خاصية الوجود الحديث. والأساس الذي قام عليه نوع غير مسبوق من الحرية مهما بالغنا في حسن الظنّ بالمفهوم الحديث للثورة: هو ما سمّاه هيغل “الحرية المطلقة” إطارًا بيو-سياسي للرعب البشري. وهي مطلقة في معنى أنّها لحظة اكتشاف الأنا الحديث أنّه حرّ، ولكن في معنى أنّ كلّ ما يحيط به هو مجرّد “موضوع” لوعيه، ومن ثمّ أنّه يحمل في قبضته “ماهية كلّ الكتل الروحية للعالم الواقعي كما للعالم فوق الطبيعي”. فجأة تنقلب الحرية إلى وعي يفترض أنّه وعي “بكلّ واقع روحي، وأنّ كل واقع هو فقط شيء روحي، والعالم هو فقط إرادته، وأنّ هذه الإرادة هي إرادة كلية”.
هذا النوع من الحرية المطلقة الذي وضعته الثورة الفرنسية موضع التنفيذ هو مفهوم الحرية الذي تأسس عليه نمط استعمال الموت منذ قرنين: إنّه الموت بلا معنى خاص. الموت الذي يفترض على الرغم من ذلك أنّه في ماهيته موت روحيّ لأنّ الوعي بالموت ليس غريبًا عن العالم الذي قتله بل هو عالمه الخاص أو أثر ميتافيزيقي لإرادته؛ وهو بلا معنى لأنّه يختلف عن الموت قبل الحديث بأنّه موت غير أخلاقي أو موت ليس له رسالة. هو موت غير شخصي أيضًا في معنى أنّه لا يدّعي أنّه يقف خارج شخصية العالم الذي يقتله. بل هو التعبير العميق عنه.
ولذلك حين أعلن نيتشه عن مجيء العدمية أي الانهيار الكامل لجميع القيم المؤسسة للإنسانية التقليدية، هو في الحقيقة لا يخترع عصرًا جديدًا، بل هو يصفه فقط أو يسرده بشكل مختلف. ثمّ توالت الأحداث الكبرى في ضمير الغرب: بعد “موت الإله” الأخلاقي (نيتشه) وبعد “الجحيم هم الآخرون” (سارتر) و”تفاهة الشر” (حنّا أرندت) و”موت الإنسان” (فوكو) وعصر “الإرهاب” (“مفهوم 11 أيلول” حسب دريدا)..جاء وقت تفاهة القتل ما بعد الحديث.
علينا أن نكفّ عن الجدل حول علاقة الإرهاب بالدين، بهذا الدين. “هذا الإسلام” (حسب عبارة فوكو حينما كان يرسل تقارير من طهران عن “الثورة الإيرانية” في أواخر السبعينات) ليس “ذات” الإرهاب وإن كان لا يستطيع أن يعفي نفسه من أن يكون “موضوعًا” له. وإنّ “الإلحاد المفهومي” (حتى نستعمل عبارة رشيقة لجون لوك ماريون) لم يعد يكفي كي نبرّئ ذمّتنا “الحداثية” من الانتماء إليه، نعني إلى تلك المدوّنة الرائعة التي لا تخلو من تاريخ عميق في تقنيات القتل.
إنّ تفاهة القتل قد أصبحت المشهد الأخلاقي للإنسان الأخير. ونحن نقول للمسلم الأخير أيضًا. هذا النمط البشري الذي يشعر بأنّ حربه حربان، كما كان يقول درويش في قصيدة “سرحان”: حرب الذين قتلوه وحرب الذي جعلوا قتله ممكنًا.
ولكن ماذا يقصد القاتل؟ – ترون كيف نسأله أسئلة تقليدية جدًّا، وأنّ موضة القتل ما بعد الحديثة- أي تلك التي أسقطت ورقة التوت الحداثية واستغنت عن كل أنواع التنوير- لم تعد تحفل بالأسئلة. هل هذا القاتل المشهدي هو كوجيطو ديكارتي ظلّ طريقه إلى عصر التنوير؟ هل القتل تمرين جديد في “نقد العقل” الذي كنّا نعوّل عليه كي نلتحق بالركب الإبستيمولوجي للغرب؟ وهل نحن واجهة الاتهام الوحيدة في هذا العالم الهشّ أكثر من أيّ وقت مضى؟ هل يكفي النسب البيولوجي أو “الإتني” أو الديني أو الجغرافي أو اللغوي كي نثبت تهمة القتل على شخص ما أو على أمّة ما؟
منذ نيتشه تمّ الإعلان عن موت الإله الأخلاقي. وتمّ تدشين عصر العدمية. والرهط العدمي هو نمط بشري لم يعد فحسب يؤمن بسلم القيم التقليدية بل هو من انخرط في تنفيذ تكنولوجي لبرنامج “أفول الأصنام”. وكان هذا بمثابة بشرى ما بعد دينية بنوع جديد من عصور الأنوار: تلك التي تفسح المجال إلى ظهور “آلهة جديدة” على الأرض، شكل الكينونة “الوحيد” في أفق الحيوان البشري. لكنّ تدبير العالم بعد موت الإله لم يؤدّ إلاّ إلى حروب دينية ما بعد تاريخية. حروب من دون مؤمنين. بل فقط: برامج قتل عدمي يدّعي أنّه أفضل وضعية “بيو-سياسية” يمكن توفيرها لظاهرة “السكّان” في مجتمعات “المراقبة والعقاب”.
ولكن لماذا نشعر إذن بأنّنا “متّهمون” إلى هذا الحدّ؟ يمتاز المسيحيون في تاريخ الأخلاق بأنّهم شعوب “الخطيئة” وبأنّ “وخز الضمير” هو مكنة المسؤولية الفريدة من نوعها التي يتميزون بها على مستوى الإنسانية. المسيحي لا يشعر بأنّه “متّهم” بل بأنّه “مذنب”. والمزعج هنا هو أنّ المسلم يشعر بالعكس: إنّه أقلّ ما يكون مذنبًا وأكثر ما يكون متهمًا. لا نعني الذنب القانوني. الذنب ليس قيمة قانونية إلاّ عرضًا. ومنذ جنيالوجيا الأخلاق تعلّم المعاصرون كيف يعيدون تنزيل مقولة “الذنب” في تاريخ الدّين وإشكالية الاضطغان التي ترتبط بها. لكنّ المسلم يشعر دومًا وبشكل صفيق بأنّه غير معني بكلّ سرديات موت الإله وكلّ مشاكل الضمير التي تقوم عليها.
نحن متّهمون لأنّ تاريخ الحقيقة الذي تأسست عليه سردية الإسلام هو تاريخ لا يستثني القتل من ماهيته. ومثلنا مثل اليهود أو اليونان، نحن نؤرّخ لمعاركنا وحروبنا بشكل مهيب. إنّ هويتنا هي تاريخ معاركنا. والذاكرة الحربية ذاكرة هووية دائمًا. ولكن هل يكفي أن تزعم المسيحية أنّ الإله قد مات من أجلها على الصليب حتى تبرّئ ذمّتها من ذاكرة القتل؟ أليس موت المسيح جزءًا لا يتجزّأ من تاريخ القتل؟ ما الفرق في آخر المطاف بين إله يأمر بقتل البشر الوثنيين بوصفه وسيلةً تاريخيةً لتطبيق الشريعة وإله يستعمل موته على الصليب الوثني أداةً لتنصيب العدمية في أفق البشر؟
ربما آن الأوان لأن نتحقق من الفرق بين العدمية الأوروبية والإرهاب الإسلاموي.- قد يُقال إنّ “العدمية” (nihilism) نتيجة لانهيار الإيمان بالإله المسيحي ونقد الدين من طرف التنويريين ثمّ إعلان “موت الإله” مع نيتشه وأدباء القرن التاسع عشر؛ أو هو نتيجة لضرب من “تأليه الإنسان” بدأ مع ديكارت والعقلانيات الكبرى للقرن السابع عشر (سبينوزا، ليبنتز..) وبلغ أوجه مع دراما سردية “العقل في التاريخ” مع هيغل؛ أو هو أمارة على “نزع السحر” عن العالم الذي نتج عن الرأسمالية (فيبر)؛ أو هو علامة على “وحشة” الإنسان في العالم في عصر التقنية كعصر بلا “موطن” روحي أو بلا “كينونة” (ياسبرس، هيدغر..). أو هو بعامة نتيجة أخلاقية عميقة لتطوّر فكرة “الحداثة” أي فكرة تنصيب مبدأ الذاتية مركزًا لإدارة العالم، سواء أكان فضاء تاريخيًّا-اجتماعيًّا لتشكيل الهوية الإنسانية ما بعد التقليدية، أم فضاءً سرديًّا لتملّك تاريخ الإنسانية برمّتها وتحويلها إلى مخزون سردي خاص أو تحت إمرة الغرب.
لكنّ “الإرهاب” (terrorism) هو في مقابل ذلك ظاهرة جديدة، ما بعد حديثة تطال ظاهرة الحداثة نفسها وتعادي مبدأ الذاتية وجملة آداب الجسد والحرية والفردية، إلخ.. التي نتجت عنها. فهو نتيجة دين معيّن وثقافة معينة ولغة معينة، إلخ… قد يُقال.
في حقيقة الأمر إنّ مراجعة تاريخ تكوّن المصطلحات قد يلقي ضوءًا مثيرًا على وجاهة استعمال المفاهيم. – فإنّ أوّل ظهور لمصطلح “العدمية” يبدو أنّه يعود إلى سنة 1733 في كتاب في علم اللاهوت ظلّ مجهولاً[1]. لكنّ المعروف أنّه بعد سنة 1787 أو سنة 1792 قد انتشر المصطلح، نحته ناسكٌ ألماني متصوّف وغريب الأطوار يُدعى جاكوب هرمان أوبريت (Jacob Hermann Obereit)، وقد استعمله لوصف مفهوم “الشيء-في-ذاته” الذي نصّبه الكانطيون الراديكاليون في مكان الإله نفسه، وبالتالي وصف “المثالية الترنسندنتالية” باعتبارها لا تعدو أن تكون “نزعة عدمية”. لكنّ من أذاع المصطلح وكرّسه في هذا المعنى الأخير هو اللاهوتي والتقويّ الألماني جاكوبي في رسالة إلى فيشته بتاريخ 1799، وهو المصدر المشهور حول هذا الأمر واصفًا المثالية بأنّها عدميّة. والرسالة معاصرة لمحنة فيتشه إبّان خصومة الإلحاد. ويبدو أنّ جاكوبي كتب الرسالة لرسم مسافة علنية عن فيشته الذي يعرف عنه بأنّه مناصر للثورة الفرنسية.
يقول جاكوبي: “إنّ أمام الإنسان اختيارًا واحدًا ووحيدًا: العدم أو الله. عند اختيار العدم هو يجعل من نفسه هو الله؛ ذلك يعني هو يجعل من الله ظاهرة، إذ أنّه من المستحيل، إذا لم يكن هناك إله، على الإنسان وكل ما هو حوله أن يكون أكثر من مجرد ظاهرة. أنا أعيد: الله موجود وهو موجود خارج ذاتي، وهو ماهية حية قائمة لذاتها، أو أنّني أنا هو الله. ليس هناك من إمكانية ثالثة”.
وربما علينا أن نشير أيضًا إلى مصطلح استعمله الفرنسيون (سنة 1801) في تلك الحقبة ألا وهو “rienniste” للإشارة إلى اليعقوبيين المتطرفين باعتبارهم عبّاد “اللاشيء”.
وإنّ أوّل ظهور لمصطلح “الإرهاب” هو في القرن الثامن عشر، وبالتحديد في نوفمبر 1974، وتمّ تثبيته في المعاجم انطلاقًا من سنة 1798، إبّان توصيف الفترة التي خصّصتها الثورة الفرنسية لتصفية كلّ “المضادين للثورة”. ويستعمل المؤرخون مصطلح “la Terreur” للإشارة إلى فترتين: فترة “الإرهاب الأول” (la première Terreur) بين أغسطس وأيلول من سنة 1792، بين سقوط الملكية وإعلان الجمهورية؛ وفترة “الإرهاب الثاني” (la seconde Terreur) وهي تمتد من يونيو 1793 إلى يوليو 1794، من سقوط “الجيرونديين” إلى قتل روبسبيار. الإرهاب مصطلح استحدثته الثورة الفرنسية وطبّقته أداةَ تصفية نسقيّة ومنظّمة وإجرائية بحتة لأعداء الثورة.
ماذا يعني هذا التذكير؟ – أنّ الإرهاب ليس ظاهرة دينية بل هو اختراع خاص جدًّا بالثورة الفرنسية. وهو أسلوبها المكرّس لتصفية المعارضين باعتبارهم “مضادّين للثورة”. وهو تهمة ما بعد دينيّة تمامًا، تهمة “علمانيّة” تمامًا. وأنّ العدميّة هي ردّ الفعل الروحي العميق على موت الإله الأخلاقي في أوربا في نهاية القرن التاسع عشر. ومن ثمّ أنّ الإرهاب والعدميّة لم يظهرا فحسب في فترة تاريخية واحدة بل هما ربما كانا ضربًا صامتًا من الترجمة الترنسندنتالية للذاتية الأوروبية الخارجة من نطاق “العالم القديم”/المسيحية اليومية، إلى أفق المجتمع العلماني – أي الذي علمن القيم المسيحية وحوّلها إلى جهاز “حداثة” عنيف لأنّه يستعمل العلاقة “ذات/ موضوع” بوصفها إستراتيجية السيطرة على العالم وتملّكه. ولذلك لا يقع “إرهاب” إلاّ بقدر ما نفترض أنّ “الآخر” (أكان شيئًا أم شخصًا) هو “عدم” أو “لاشيء”، ومن ثمّ أنّه لا يملك أيّ “أصالة” جوهرية تمتنع عن السقوط تحت “النظرة” الإرهابية إلى العالم.
إنّ الأمر يتعلق في الحالتين بضرب من “التنوير العنيف”. والعدمية والإرهاب وجهان لعملة واحدة: هي الحداثة الأوروبية كما أرّخت لنفسها، وليس كما قد يحدث أن يعاديها سلفيّون يظنّون أنّهم يحتكرون “هوية” الإرهاب أي الاستعمال “الأصولي” للحرية المطلقة. علينا أن نفصل فصلاً حادًّا بين “انتظاراتنا” من الحداثة (سياسات الأمل التي تأسست عليها كل إعلانات الاستقلال في بلداننا التي تعاني من “الحداثة الموازية”) وبين البنى الهووية التي تشكّل في ضوئها التاريخ الداخلي للحداثة أي ما سمّاه فوكو “تاريخ الذات” (تكوين الهوية الحديثة كما وصفها تايلور) في مقابل “تاريخ الآخر” (المريض، المجنون، المسجون، المثلي…). ومن ثمّ فإنّ تهمة الإرهاب ليست حكرًا على الثقافات “غير الحديثة”. فهي تعاني أيضًا من تخلّف تقني في مقاومة الإرهاب أيضًا. ومثقّفوها، حتى نستعمل عبارة رشيقة لجياني فاتيمو، هم “ليسوا عدميين بما فيه الكفاية”.
السؤال إذن هو: متى نبدأ، أو يبدؤون، في وصفنا أو سردنا بالاعتماد على معجم يعرفنا أو مفردات تنتمي إلينا؟ يبدو أنّنا لن نشرع فعلاً في التفكير الجذري في مشاكلنا إلاّ عندما نكفّ عن الجدل حولها بالاعتماد على جهاز اصطلاحي لا نسيطر على تشكّله التاريخي ولا على سياسة الخطاب التي أنتجته. ثمّة نوع من الإخصاء يطال المفاهيم أيضًا. وذلك عندما يتمّ توسيع منطقة الممنوع حول ما ينبغي قوله لأنفسنا وتعويضها بوطاويط رسمية تؤبّد المشاكل من فرط الحرص على تزلّف حجة السلطة التي لا يبدو أنّها تساوم على أيّ شبر من تسلّطها. لا يتعلق الأمر بفساد أو إصلاح الأديان؛ فهذه مهنة عفا عليها الزمن الحديث؛ بل بإصلاح الإنسان. إنّ الإرهابي الوحيد والعدميّ الوحيد في كل مكان هو الإنسان، وليس العقائد أو الأفكار. إنّ تحرير الإنسان من خوفه – مهما كان موضوع هذا الخوف- هو الطريق الوحيد لتحرّره من العدميين والإرهابيين، أي من حاجته “البريئة” إلى القتل.
أليست البراءة هي الوجه الآخر من تفاهة القتل؟ طالما لا يمكن دعوة الآخر إلى مشاركة الإنسانية بمجرّدها، ثمّة براءة تتعالى على الجميع. وكلّ ادّعاء براءة يتجاوز الإنسان هو مشروع للقتل. وإنّ أكبر تشريع روحي للقتل هو ادّعاء احتكار منطقة البراءة وتأسيسها على أيّ ضرب من التعالي. ويبدو أنّ مستقبل كل تصوّراتنا الدينية عن “الله” – مثل كل مفاهيمنا الأخلاقية عن “الإله” – مثل كل مقولاتنا الجمالية عن “الألوهية” – هو رهين استعدادنا للقبول بمراجعة رسميّة وعلنيّة لفكرتنا عن “التعالي”، أي لكل أنواع التقديس في ثقافتنا العميقة.
ثمّة أسئلة حول منطقة المقدّس أُجّلت طويلاً وآن الأوان لطرح بعضها أو إعادة طرحه، وإن كانت معالجتها الفلسفية الحاسمة سوف تنتظر جيلاً أو أجيالاً أخرى. علينا منذ الآن أن نقبل بهكذا تساؤلات دون تحفّظات رسمية: كيف نستعمل مقدّساتنا في المستقبل؟ ما هي أوجه طريقة للحديث العمومي عن الله؟ كيف نحمي فكرة الله من المؤمنين به؟ ولماذا تمّ اختزال شخصية النبي في شخصية الشهيد أو المقاتل؟ هل يحتوي الدين على استعداد خاص لصناعة الموت؟ وهل الحل هو إخراج الدين من النقاش العام؟ هل ثمة “إبوخيا” روحية؟ أليست “الأصولية” التي بلغت أوجها مع “داعش” هي جزء لا يتجزأ من سياسة الحقيقة في تاريخنا العميق؟ ولماذا لا نحصر الإيمان في دائرة الشخصي والخاص مثلما فعل بعض المتصوّفة؟ هل ثمّة جدوى ديمقراطية من الخلط بين الدين والحياة؟ ما المانع من فهم النصوص المقدّسة بوصفها آثارًا جماليةً بحتة؟ وما المانع من الاعتراف بحق غير المؤمنين في المشاركة في بلورة علاقة أكثر طرافة بين الحقيقة والحياة؟ هل يمكن تبرير الإرهاب باعتباره مقاومة شريفة؟ إلى متى يجوز أن تعوّل دولٌ بأكملها على الاحتكام إلى “علوم شرعية” قبل-حديثة انهار البراديغم الإبستيمولوجي الذي تأسّست عليه؟ …بيد أنّه ليس من فائدة محدّدة في الأجوبة عن هذه الأسئلة بل فقط: أن تنجح في رسم فضاءات اختلاف لائقة ونبيلة وصحّية بين المنتمين إلى المجتمع نفسه هي وحدها كفيلة بتأجيل أيّ حاجة إلى قتل الآخر بما هو كذلك، أو إلغائها.
وإذا كان ثمّة من معنى قد بقي للحديث عن “الاجتهاد” فهو هذا: أن نراجع فكرتنا العميقة عن “المقدّس”، وأن نعيد تربية الإنسان لدينا على هذا الأساس. لم يعد ينحصر أو يتعلق الأمر بالدفاع عن هويتنا أو عن ثوابت الأمة أو عن رسالتها الأخلاقية أو براءتنا من الإرهاب، …فهذه المطالب كلها، على مشروعيتها أو وجاهتها أو نبلها، هي مطالب جيل آخر، ولى وانتهى. لا يوجد إنسان بريء من تاريخه. لكنّ الغرب ليس هو المحكمة الكونية الوحيدة. علينا أن نثبت براءتنا، أي عدم حاجتنا التاريخية إلى القتل، – ليس باعتناق كلّ تقليعات الغرب الجمالية والأخلاقية والقانونية والسياسية… بل باعتناق أنفسنا العميقة، وهو ما يفترض أن نؤرّخ لخطورتنا الخاصة، وعلاقتنا الخاصة بالعدم، وأن نكتب تاريخ الإرهاب الخاص بكينونتنا في العالم دون أيّ وجل أو خجل. إلاّ أنّ شرط إمكان كل ذلك لا ينبغي أن يُنسى أو أن يحوّل إلى موضوع تفاوض سخيف: إنّه حرية الانتماء إلى أنفسنا. الحرية هي الوصية الأخيرة للأحياء. ما بقي هو مدوّنات للموتى.
[1]– F. L. Groetzius, De nonismo et nihilismo in theologia (1733).
* كاتب ومفكر تونسي، أستاذ التعليم العالي في الفلسفة المعاصرة في جامعة تونس. من مؤلفاته: “هيجل ونهاية الميتافيزيقا” (1997)، و”نقد العقل التأويلي” (2005)، وغيرها. ومن ترجماته: “في جينيالوجيا الأخلاق لفريديرك” تيتشه (2010)، و”الكينونة والزمان” لمارتن هايدجر (2013). نشر العديد من المقالات والدراسات في المجلات والصحف التونسية والعربية والأجنبية.
عن “مؤمنون بلا حدود”
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…