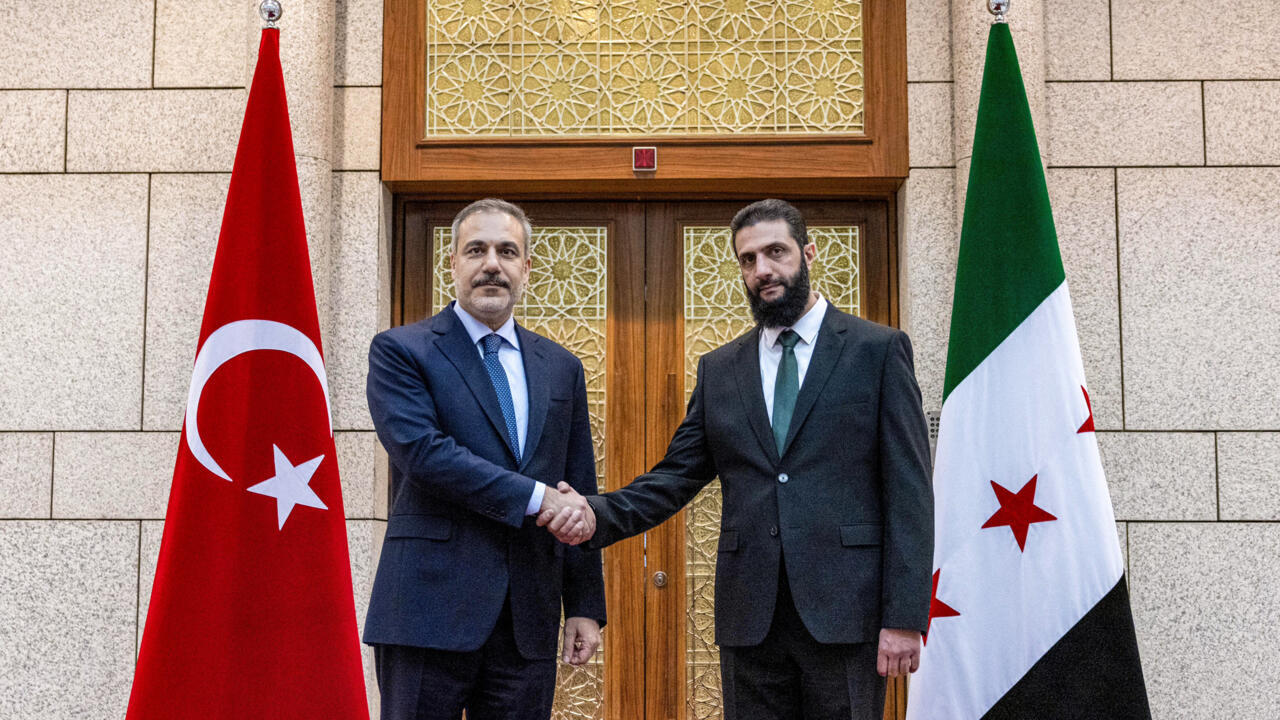سماح إدريس
هل اللغة العربيّة في أزمة؟
الأنظمة العربيّة في أزمة. الأحزاب العربيّة في أزمة. التربية العربيّة في أزمة. القراءة العربيّة في أزمة. الشعر العربيّ في أزمة. المسرح العربيّ في أزمة. الكتاب العربيّ في أزمة. القضيّة الفلسطينيّة في أزمة. فلماذا لا تكون اللغةُ العربيّةُ في أزمة؟
أهي جزءٌ متعالٍ عن البشر والمجتمع، فلا تَخضع لعوامل التراجع أو التكلُّس، لمجرّدِ أنّها لغةُ دينٍ مقدّس؟
لكنْ ما الذي نعنيه تمامًا بـ”الأزمة”؟
يخيَّل إلي أنّنا أدمنّا الحديثَ عن “الأزمة” من دون شرح أسبابها ومكوِّناتِها حتى فقدتِ الكلمةُ معناها، وتحوّلتْ إلى مصطلحٍ إضافيّ من مصطلحات جلْد الذات العربيّة، بحيث لم تعد تؤدّي إلّا إلى الإحباط والتطلّعِ بدونيّةٍ وانبهارٍ إلى المستعمِر الأقوى.
إذا كان لي أن ألخّصَ بعضَ أسباب أزمة اللغة العربيّة، فهي في رأيي كالآتي:
أوّلًا، أزمةُ العربيّة جزءٌ من أزمتنا في هذا العالم، الذي نشكِّل فيه، نحن العربَ وشعوبَ العالم الثالث، طرفَه الأضعفَ على كلّ الصعد. ولا يغيِّر من هذه الحقيقة أنّ بعضَ دولنا يَحوز أهمَّ ثروات النِفط والغاز في العالم، ولا أنّ تَرساناتِها العسكريّةَ تَختزن آخرَ تِقْنِيّات القتل والتدمير، ولا أنّ بعضَ علمائنا ومثقّفينا وأدبائنا يتلقّى أبرزَ الجوائز العالميّة ويتبوّأُ أعلى المناصب الدَولية. في هذا العالم المختلّ لغيرِ صالحنا، سيَصْعب أن تنموَ ثقافتُنا على النحوِ الذي نشتهيه.
فالثقافة، وضمنَها طبعًا اللغةُ والإنتاجُ الأدبيُّ والفلسفيُّ والبحثيُّ والعلميُّ والفنّيّ، تحتاج إلى دعمٍ ورعايةٍ ووسائلِ تدريبٍ وتطويرٍ وورشِ عملٍ ومؤتمراتٍ ومختبرات. وتحتاج إلى أوسع قدْرٍ من الحريّة، بعيدًا من سيف الرقابة والقمعِ والترهيبِ والتهديدِ بلقمة العيش. اللغة، شأنُها في ذلك شأنُ أيِّ كائنٍ أو مؤسّسةٍ أو نبتةٍ، لا يمكن أن تنموَ بالرَغَبات وحدها، ولا بالركونِ إلى ماضٍ مجيد. وواقعُ الأمر، للأسف، أنّ الثقافة في كثيرٍ من أقطارنا لا تحظى إلّا بأضعفِ أشكال الدعم الرسميّ؛ فميزانيّةُ وزارة الثقافة في لبنان، مثلًا، وهو الذي يتباهى بأنّه بلدُ الحرف والأبجديّة ودُورِ النشر، أقلُّ من واحدٍ في المئة من ميزانيّة الحكومة. فعَلامَ سيعتمد الكاتبُ الناشئُ أو باحثُ اللغة في لبنان؟ وكيف سيتطوّر الإنتاجُ الثقافيّ، وضمنه اللغةُ كما ذكرنا… علمًا أنّ اهتمامَ القطاع الخاصّ بهذا المجال يتراجع هو الآخر لأسبابٍ كثيرةٍ، أهمُّها أنّه “لم يعد يُطْعم خبزًا”؟
ِ
“داعش” تهدم متحفَ الموصل.
فإذا أضفنا إلى ذلك واقعَ الحروب والحصارات التي ابتُلينا بها، لا عن مصادفةٍ بل عن سابقِ تصوّرٍ وتصميم، فسنجد أنّ ما كان يُعتبر حتى الأمسِ القريب من الحواضر الأساسيّة للثقافة العربيّة القديمةِ والحديثة قد دُمّر، ونُهبتْ آثارُه، وأُحرقتْ مكتباتُه، وجُوِّع شعبُه، وهُجِّر مواطنوه، على يد المستعمِرين والتكفيريين، خصوصًا في العراق وسوريا؛ وكانت الجزائرُ قد نالت حِصّتَها الرهيبةَ من تدمير الإرهاب التكفيريّ قبل ذلك، أيْ خلال ما يسمى “العَشْرية السوداء.” وما أنسَ لا أنسَ المأساةَ الكبرى التي حلّت بمثقّفي العراق، الذين اضطُرّوا إلى بيع كتبهم كي يُجنّبوا أنفسَهم غائلةَ الجوعِ والفقر.
وعليه، فإنّنا لا نستطيعُ أن نتحدّث عن “أزمة اللغة العربيّة” في معزِلٍ عن تدمير حواضرِها الأساسيّة بفعل الحروب الخارجيّة والداخليّة، وما رافق ذلك من تراجع القطاع المدرسيّ (بل خرابِ المدارس نفسها أحيانًا)، ومن توقّفِ معارض الكتب السنويّة، وتقهقرِ سوقِ النشر، وعدمِ انتظامِ عمل المعاهدِ والمجامعِ اللغويّة.
***
ثانيًا، أزمةُ اللغة العربيّة هي من أزمةِ قسمٍ من دارسيها والمهتمّين بها. في عالمِ اللغة، كما في عالم السياسة والاقتصاد، رجعيّون وتقدّميّون، محافِظون ومغامِرون، متقوقعون ومنفتحون، متزمِّتون ومصلِحون. وأنا أزعم أنّ لغتَنا تطوّرتْ بشكلٍ كبير، واستطاعت استدخالَ مكوِّناتٍ جديدةٍ كثيرةٍ في حقول علوم التكنولوجيا والتواصل والاجتماع والنفس والفلسفة والنقد والفنّ والمسرح، بما يَنقض زعمَ الجُهّال أنّ العربيّة “عاجزةٌ عن مواكبة العصر.” وقد جاء هذا الاستدخالُ عن طريق التعريبِ أو الاستعارةِ المباشرة من لغاتٍ أخرى، وبعَفَويةٍ ورحابةِ صدرٍ أحيانًا.
غير أنّ قسمًا من المهتمّين بلغتنا ما يزال يتعامل مع هذا التطوّر بروحٍ استجنابيّة، فيعتبره “دخيلًا” على لغتنا “الأصيلة،” بما يشْبه تعاملَ العنصريين مع النازحين من بلدٍ مجاور أو بعيد.
هؤلاء يزيدون في تقوقع لغتنا على نفسها، وعزلتِها عن رياح التثاقف. والمفارقة أنّهم يتذرّعون، في مواقفهم هذه، بحرصهم الفائقِ على اللغة، فينطبقُ عليهم المثلُ السائر: “ومن الحبّ ما قتل!” وقد يشعر كثيرون منّا أنّ أجدادَنا اللغويين كانوا أكثرَ تقدّمًا وانفتاحًا من هؤلاء “الحريصين” اليوم، فلم يصابوا ــــ مثلَهم ــــ بالذعر إذا سمعوا كلمةً من أصلٍ غيرِ عربيّ. بل إنّ مؤلّفَ تاج العروس نفسَه لم يشعرْ بأيّ حرجٍ من إدراج كلمة “باس” في معجمه، وردّها إلى الفارسيّة “بوسيدَنْ.”
إنّ مجرّدَ التعاطي مع تأثير اللغات الأخرى في لغتنا وكأنّه ــــ بالضرورةِ ــــ “اجتياحٌ” يهدِّدُها ويهدِّدُ ذاتَنا وحضارتَنا وثقافتَنا ودينَنا، بدلًا من أن يكونَ تلاقحًا وتثاقفًا يمكن أن نُفيدَ منهما، إنّما يدلُّ على قلّة ثقةٍ بالنفس أوّلًا، وباللغةِ العربيّة ثانيًا، وهي التي استطاعت الصمودَ قرونًا طويلةً. والحقّ أنّنا قد نتفهّم بعضَ منطلقاتِ ذلك الحرص المتزمّت؛ فنحن أمّةٌ مهزومةٌ، مستهدَفةٌ من عتاة الاستعماريين والصهاينة، وتتعرّضُ لشتّى ضروب الطعن والتجريح على يد بعضِ المستشرقين وطلّابهم؛ ولغتُنا أهمُّ ما نعتزّ به لأسبابٍ كثيرة، منها أنّها اللغةُ التي نزل بها القرآنُ الكريم. لكنْ، إذا كان القرآنُ مقدّسًا، فذلك لا يعني، كما سبق الذكر، أن نتعاملَ مع العربيّة وكأنّها مقدَّسةٌ هي الأخرى، ترفض التجديدَ والاستدخالَ بذريعة “النقاء.”
***
(طالبتان من ثانوية فرج معلّا في أمّ القيوين (الإمارات العربيّة) تطالعان قصص الكاتب)
ثالثًا، أزمة اللغة العربيّة من أزمة بعضِ المربِّيات والمربّين. وأعني، تحديدًا، أولئك الذين يستعذبون التسلّطَ الأبويّ، في المدارس والثانويات، على أطفالنا وناشئتِنا، فينهَرونهم كلّما ارتكبوا “جريمةَ” التلفّظ بكلمةٍ “غريبة” أو يتوهّمون أنّها عامّيّة.
ولقد سبق أن ذكرتُ، في مقال آخر، أنّ ابنتي سارية، حين كانت طفلةً، طُلب إليها في المدرسة أن تضع كلمةَ “طعام” في جملةٍ مفيدة، فكتبتْ: “حطّ البابا الطعامَ في صحني،” فوضعت المعلِّمةُ دائرةً حمراءَ حول كلمة “حطّ” وكتبتْ تحتها: “لا تستعملي العامّيّةَ يا سارية.” حين جاءتني سارية تطلب إليّ أن أوقّعَ على فرضها اليوميّ فوجئتُ بإجابة المعلّمة، فكتبتُ تحتها: “ولكنّ امرأ القيس أنشدَ في معلّقته: “مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقبلٍ مُدبِرٍ معًا كجُلمودِ صخرٍ حطّهُ السيْلُ مِن عَلِ.” المعلِّمة لم تجب. بعد أسبوع طلبتْ إلى سارية أن تضعَ كلمة “حجر” في جملةٍ مفيدة، فكتبتْ سارية: “كبَّ البابا الحجرَ في الماء.” فأعادت المعلمةُ “تذكيرَها” بوجوب استخدام “الفصحى” ورسمتْ دائرةً حمراءَ أخرى، هذه المرّة حول كلمة “كبّ.” عادت سارية إليّ من جديد كي أوقِّعَ، ومن جديدٍ رفضتُ أن أكون شاهدَ زُورٍ على ما يُرتكب في حقّ لغتِنا من تزمّتٍ جاهل، فكتبتُ: “جاء في القرآن الكريم: ومَن جاء بالسيّئةِ فكُبّتْ وجوهُهم في النّارِ.” حينها، اتّصلت المعلِّمة بي وطلبتْ لقائي وقالت بالحرفِ الواحد: “صرتُ أخاف أن أصحِّحَ للأولاد أيَّ شيء.” قلتُ ضاحكًا: “هوذا المطلوب. ليس كلُّ ما نتوهّمُه عامّيًّا هو كذلك. وشعورُ الأطفال الدائم أنّهم يسيرون في حقلٍ من الألغام كلّما كتبوا كلمةً بالعربيّة لن يشجِّعَهم على التقرّب إلى هذه اللغة كي لا تنفجرَ في وجوههم!”
والتأنيبُ نفسُه يلقاه، مِن المربّي أو المربّية، المؤلّفُ نفسُه إنِ ارتكبَ “جريمةَ” إدخالِ كلمةٍ أجنبيّةٍ أو عامّيّةٍ في أحد كتبه، ولو في معرِضِ حوارٍ بين شخصيّاتٍ روائيّةٍ أو مسرحيّة. أذْكرُ أيضًا أنّ إحدى المربِّيات اعترضتْ على السماح بكتبي في مكتبةِ مدْرسةٍ لبنانيّة لأنّني استخدمتُ ــــ والعياذُ بالله ــــ كلمةَ “أوكي” على لسان طفلٍ صغير، وذلك في قصّةٍ لي، هي قصّةُ الكوسى، وحثّت المديرةَ على سحب كتبي من مكتبةِ المدرسة. المربّية هنا كانت تمارس دورَ “السلطة اللغويّة” من دون أدنى نقاش، وتحديدًا من دون أن تستمعَ إلى مقولاتٍ فنّيّة أسلوبيّةٍ من قبيل أنّ “الواقعيّة” في الفنّ قد تُلزم الكاتبَ بإدراج بعضِ الكلمات والتعابير من خارج اللغة العربيّة، وخصوصًا في الحوار، من دون أن يتسبّبَ ذلك في تشويه أخلاق أطفالنا أو انهيارِ صرحِ اللغة العربيّة أو الأمّةِ العربيّة!
***
رابعًا، أزمة اللغة العربية يتحمّل المسؤوليّةَ عنها بعضُ الأهل أيضًا. وهنا أخصُّ بالذكر الأهلَ الذين لا يَكُفّون عن تأنيبِ المدارس لتهاونها في شأن العربيّة لصالح اللغات الأخرى. لكنّهم ماذا يفعلون في المقابل؟ يتحدّثون إلى أطفالهم بالإنجليزيّة أو الفرنسيّة، أو بخليطٍ مضطربٍ من اللغات، أو يتركونهم في رعاية عاملاتِ منزلٍ لطيفاتٍ ومتفانياتٍ ــــ ولكنّ غالبيّتَهنّ لا يتحدّثن العربيّةَ على الإطلاق.
ولا بدَّ من القول إنّ بعضَ الأهل يستحقّون التأنيبَ من زاويةٍ أخرى، وذلك حين يلومون أولادَهم على قلّة المطالعة من أجل تعزيز مخزونهم اللغويّ العربيّ (وغير العربيّ)، ولكنّهم (أي الأهل) يَصرفون الساعاتِ تلوَ الساعات أمام التلفاز، وقلّما ظهروا أمام أولادهم وهم يطالعون كتابًا أو مجلّةً ثقافيّةً باللغة العربيّة. فإذا كان على هذه الشاكلة مَن يُفترض أن يكونوا مثالًا أعلى لأولادهم، فماذا تتوقّعون من هؤلاء الأولاد؟!
***
خامسًا، أزمةُ العربية من أزمتنا، نحن الكتّاب. نلوم الناسَ على تراجع قراءتهم بالعربيّة، ولكنّ بعضَنا يَبذل قُصارى جُهده في تنفيرِهم منها. ويأتي هذا التنفيرُ على مستويات عدّة:
أ) عند الكتابة للطفل، نبالغ في حرصنا على “تشريبه” العِبَرَ. المشكلة ليست بالضرورة في هذه الأخيرة ــــ وقد لا تكون ثمّة كتابةٌ، وخصوصًا حين تُوجَّهُ إلى هذه الفئة العمريّة، من غير عِبرةٍ، ولو ادّعى الكاتبُ خلافَ ذلك. المشكلة هي في أسلوب الوعظ، الذي يُشعر الطفلَ وكأنّه خرج من المدرسة ليَدخلَ في مدرسةٍ أخرى. وخطورةُ ذلك أنّ الطفل لن يكتفي بمماهاة الكتبِ العربيّة بالوعظ والتلقينِ المملّيْن، وإنّما سيذهب إلى اعتبار اللغةِ العربيّة نفسِها مصدرًا للملل.
ب) عند الكتابة للطفل أيضًا، يبالغ بعضُنا في استخدام الكلمات العويصة، وهذه المرّة من منطلق الحرص على تشريبه مفرداتٍ جديدةً. والنتيجة، طبعًا، هي تنفيرُه من العربيّة مجدّدًا، وربّما من القراءة مطلقًا، أو دفعُه إلى القراءة بلغةٍ أخرى يعرفها. وذلك لا يعود إلى أنّ مضمونَ ما يقرأُه بهذه اللغة الأخرى أقلُّ وعظًا فحسب، وإنّما يعود كذلك إلى أنّ الكاتبَ بها يكون في العادة أقلَّ هجسًا من الكاتب العربيّ بتقوية مخزون الطفل اللغويّ على حساب الإثارة والمتعة والمرح. إنّ استخدام كتّابنا لغةً عويصةً “وصفةٌ” ممتازةٌ لتنفير أطفالنا من العربيّة والعروبة!
ج) فإذا انتقلنا إلى اللغة التي يستخدمها الكتّابُ العربُ في كتاباتهم الموجَّهةِ إلى البالغين من أمثالنا، فلا شكّ في أنّنا سنلاحظ أنّ كثيرين منهم ينفّرون القرّاءَ من العربيّة هم أيضًا، من دون علمٍ أو قصد. تأمّلوا مثلًا تلك الكتبَ أو المقالاتِ البالغةَ الطول، التي كان يمكن أن تُختزلَ بنسبةٍ قد تتجاوز الثلاثين في المئة من دون أن تَفقدَ شيئًا من قوّتها أو نكهتِها أو هدفيّتِها؛ على العكس، لطالما كان الإيجازُ غيرُ المُخِلّ مبعثَ قوةٍ وإقناعٍ بما يفوق الإطنابَ والحشوَ.
على أنّ هذيْن الأخيريْن، أي الإطنابَ والحشوَ المسيئيْن إلى اللغة، لا يتحمّلُ مسؤوليّتَهما بعضُ الكتّاب وحدهم، بل يشاركهم في تحمّلها الناشرُ ورئيسُ التحرير، اللذان قلّما يتدخّلان في النصِّ المرسَلِ إليهما خشيةَ إغضابِ الكاتب. هنا لا مفرَّ من التنبيه إلى أنّ جميعَ الكتب أو المقالاتِ الصادرةِ عن كُبريات دُور النشر والدوريّاتِ العالميّة تَخضع لعمليّةِ تحرير، قد تكون جذريّةً أحيانًا، تتضمّن الاختزالَ ونقلَ مقاطعَ بأكملها إلى حيّز الهامش، وربّما شطبَ فصولٍ كاملةٍ مكرّرة، إلى جانب التصحيح أو التدقيق اللغويّ طبعًا.
وفي هذا الصدد أذكر أنني كنتُ في مكتب الراحل الكبير إدوارد سعيد في جامعة كولومبيا في نيويورك، سنة 1989 أو 1990. فأراني مخطوطةَ أحدِ كتبِه، بعد أن أرجعها إليه ناشرُه (“فيرسو” إنْ لم تخنّي الذاكرة)، وكانت مليئةً بالتشطيب والخطوطِ الصفر والحمر. ثم صاح: “شوف، يا سماح، شو عملوا فيني، أنا إدوارد سعيد!” قبل أن يضيف: “إيه، بس هلق صار كتابْ حقيقي!”
إنّ تطوير اللغة يكون بتطوير تقنيّات التحرير. وأزعمُ أنّ أبرزَ النقائص التي تعانيها المادّةُ العربيّةُ المنشورة هي نقصُ المحرِّرين ــــ ولا أقصد المدقِّقين اللغويّين بالطبع. والتحرير، كما لا يَخفى عليكم، مهنةٌ في ذاتها في الغرب، تحتاج إلى علمٍ ومراسٍ وذوقٍ وثقافةٍ ولغة.
***
ها قد حدّدنا بعضَ المسؤوليّات وبعضَ المسؤولين عن “أزمة” لغتنا اليوم، من حيث ضعفُ التداول والانتشار. وأرغبُ، ختامًا، في أن أتحدّثَ عن تجربتي الشخصيّة المتواضعة في مجال التعامل مع اللغة العربيّة بحكم وظائفي المختلفة. فأنا ناشرٌ، ورئيسُ تحرير مجلّة، وأعكفُ منذ عقود على إعداد معجمٍ مطوَّلٍ للغة العربيّة (بدأه المرحوم أبي د. سهيل وشاركه في البداية الشهيد د. صبحي الصالح)، وكاتبٌ للأطفال والناشئة، وناشطٌ في مجال مقاطعة الكيان الصهيونيّ ومناهضةِ التطبيع معه.
اللغة العربيّة، في هذه المجالات جميعِها، هي وسيلتي للتعبير والإيصال والترويجِ والتثوير، ولكنّني ــــ بحكم اختلاف فئات الناس الذين أخاطبُهم ــــ أمارسُ “عربيّاتٍ” عدّةً إذا جاز التعبير. فاستخدامي اللّغةَ ينبغي أن يتماشى مع هذه الفئات المختلفة، انطلاقًا من مبدإ “مراعاة مقتضى الحال،” أو تحقيقًا لمقولة “لكلّ مقامٍ مَقال.”
ــــ فحين أكتبُ إلى الطفل أراعي أن تأتيَ اللغةُ في أبسطِ أشكالها، وأشدِّها سلاسةً. وإنْ كان لديّ خِيارٌ بين كلمتيْن أو ثلاث، فإنّني دومًا أستخدمُ الكلمةَ الأسهلَ والأقربَ إلى مَدارك الطفل. ذلك لأنّ هدفي ليس “التفاصحَ” أمامه، ولا تقديمَ “أوراق اعتماد” لدى المدرِّسة أو المدرِّس، وإنّما تحبيبه إلى اللغة العربيّة التي يتراجع رصيدُها في بلدي مع ارتفاع رصيد الفرنسيّة والإنجليزيّة. ثمّ إنني كثيرًا ما ألجأ إلى أسماءِ علمٍ ممنوعةٍ من الصرف كي أتفادى تنوينَها؛ فقولنا “ضربتُ أسامة” أسهلُ على أذنِ الطفل من “ضربتُ وليدًا.” وحين أكتبُ إلى الطفل أيضًا، لا تتملّكني عقدةُ استخدام مفردةٍ أو أكثر بالعامّيّة أو “العامّيّة المفصَّحة،” أو باللغة الأجنبيّة، خصوصًا في الحوار.
ــــ وأمّا حين أخطب في الشارع، أو في ندوة حول مناهضة التطبيع مع العدوّ الإسرائيليّ ومقاطعتِه، فإنّني أستخدم لغةً تَجمع بين البلاغة والبساطة، لأنّ جمهوري هنا خليطٌ من المثقّفين و”العامّة.” لذا استخدم لغةً مُجسَّرة، أيْ فصحى مبسّطةً. المهمّ ألّا أتجاوزَ قواعدَ اللغة.
ــــ وأمّا حين أكتب في مجلة الآداب، فأحرصُ على استخدام لغةٍ أنيقةٍ رشيقةٍ لأنّ جمهورَ الآداب الأكبر هو من المثقفين والجامعيين.
في النهاية أقول إنّ لغتنا تحتاج إلى مناضلين، شأن أيّ قضيةٍ مهمّةٍ ومصيرية؛ مناضلين يحملون همَّ تطويرها ونشرِها ومدِّها بعناصر الحياة.
الشارقة
ورقة ألقيت في ندوة في معرض الشارقة للكتاب، بتاريخ:7/ 11/ 2017.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…