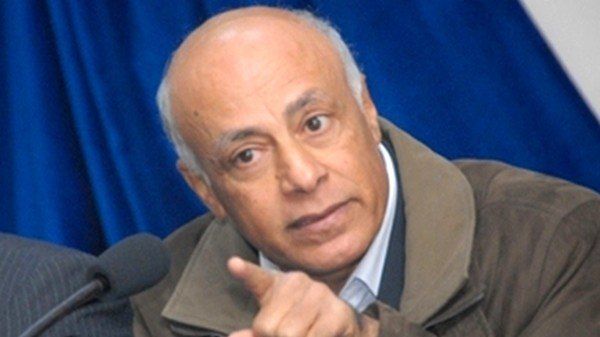محمد سعيد السعدي
تفاعل المجتمع السياسي وكثير من وسائل الاعلام مع خطاب العرش الأخير بالتنويه والاشادة بمضامينه من حيث أنه “يعطي الأولوية للقضايا الاجتماعية” ويحث على “تشجيع الاستثمار عبر رفع القيود الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار”. ودون تبخيس ما تم التطرق إليه في هذا الخطاب، نرى من الضروري لفت الانتباه إلى أن ما تم اقتراحه لا يعالج الإشكاليات الهيكلية التي يشكو منها الاقتصاد والمجتمع ولا تعدو أن تكون محاولات لتنقيح نموذج النمو النيولبرالي (أي المعتمد على ثلاثية لبرلة الاقتصاد – الخوصصة – الأولوية للتوازنات الماكرو-اقتصادية) الذي ما فتيء المغرب يسير على منواله منذ عقود، والحال أننا بحاجة إلى قطيعة مع هذا التوجه بالنظر إلى تكلفته الاجتماعية الباهظة (خاصة البطالة والاقصاء الاجتماعي وتفاقم الفوارق الطبقية والمجالية) وفشله الذريع في تحقيق التنمية المنشودة.
لاشك أن البرامج والسياسات الاجتماعية تحتاج إلى مراجعة شاملة وعميقة نظرا لضعفها وعدم فعاليتها، إلا أن التركيز على إحداث “السجل الاجتماعي الموحد” – كمدخل لحل هذه الإشكالية وكألية لإحصاء الأسر قصد الاستفادة من البرامج الاجتماعية – يعتبر مقاربة لا تخلو من نقائص وتمثل رهانا قد لا يتحقق على أرض الواقع. إن الهاجس الأساسي وراء اللجوء إلى هذه الآلية هو التخلص من “العبء” الذي يمثله صندوق المقاصة على ميزانية الدولة. لهذا، ومن أجل التخلص من هذا “لعبء” والحد من الانعكاسات السلبية لتحرير الأسعار(خاصة البوتان والقمح المدعم) على القدرة الشرائية للمواطنين، سيتم استهداف الفئات الأكثر هشاشة لدعمها بشكل مباشر من خلال الدعم المالي والعيني (من خلال الولوج الى بعض الخدمات العمومية). إن هذه المقاربة تشكو من عدة نقائص ستحد من فعاليتها : فهي تنبي أولا على تصور احساني حيث يبرز فيها جانب المساعدة الاجتماعية “للفقراء”، وهو ما يتناقض مع مفهوم المواطنة الذي يعتبر الحماية الاجتماعية حقا أساسيا يكفله الدستور المغربي بشكل متساو لكل فئات المجتمع، بغض النظر على وضعهم الاجتماعي. كما تُناقض هذه المقاربة الالتزامات الدولية للمغرب من حيث وضع أرضية الحماية الاجتماعية الوطنية في صميم نظم شاملة للحماية الاجتماعية. ثانيا، تبين التجارب الدولية قصور هذه الآلية وفشلها في حصر الفئات التي تستحق الاستفادة من الحماية الاجتماعية. وهذا راجع إلى أن التقنية المعتمدة لقياس القدرات المالية غير ناجعة لقياس مستوى فقر الأسر. على سبيل المثال، تتراوح نسبة اقصاء الأسر التي تستحق الدعم من منظور هذه المقاربة بين 50 و 93 في المائة في بعض الحالات. وهذا ما دفع بعض الباحثين إلى وصف الآلية المقترحة لاحصاء الفقراء بـ”السجل غير الاجتماعي”. ثالثا، أن المنطق وراء آلية الاستهداف هذه ليس هو الدعم الاجتماعي بقدر ما هو تقليص “الكلفة ” الاجتماعية للتخلص من صندوق المقاصة. لهذا وأخذا بعين الاعتبار هذه النقائص, من المحتمل أن يؤدي اعتماد “السجل الاجتماعي الموحد” بالموازاة مع حذف الدعم على مواد أساسية للحياة اليومية للمواطن العادي الى تدهور في القدرة الشرائية للفئات واسعة في المجتمع من الطبقات المستضعفة والفئات المتوسطة, مع ما ينجم عنه من عدم استقرار اجتماعي وسياسي.
أما المستوى الثاني من الخطاب الملكي، فيتعلق بتشجيع الاستثمار من خلال تفعيل اللاتمركز وتبسيط الإجراءات الإدارية التي تعرقل المبادرة الخاصة ونشاط المقاولات الصغرى والمتوسطة. واذا كان ورش اللامركزية من أولويات الحكامة الديمقراطية لما له من انعكاسات إيجابية على حياة المواطن ومناخ الاستثمار, فان هناك عقبات كبيرة تحول دون تنزيله على أرض الواقع نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر عائقين أساسين. أولا، التدبير العمودي وخارج الاشراف العام لرئيس الحكومة على لقطاعات وزارية وازنة تعتبر بمثابة “دولة داخل الدولة”، علما أن هذا النوع من الحكامة غير الديمقراطية ينعكس سلبا على المستوى المحلي ويجعل التنسيق والالتقائية بين المصالح الخارجية عملية معقدة وصعبة المنال. أما ثاني هاته المعيقات، فيتجلى في صعوبة توفير الموارد المادية والكفاءات البشرية الضرورية على الصعيد المحلي نظرا للسياسات التقشفية المتبعة منذ 2012 والتركيز المفرط على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وعلى رأسها تخفيض عجز الميزانية العامة للدولة الى 3 في المائة.
من جهة أخرى، تعتبر الإشارة إلى الصعوبات التي تلاقيها المقاولات الصغيرة والمتوسطة ذات دلالة نظرا للمساطر والتعقيدات الإدارية التي تحول دون نموها وازدهارها باعتبار دورها في إحداث مناصب الشغل. غير أن أهم العوائق امام هذه المقاولات تتمثل في الولوج إلى التمويل الذي لا يساعد احتكار القلة المهيمن على القطاع البنكي في توفيره. كما يشكو رأس المال المتوسط والصغير من الطابع الاحتكاري للعديد من الأنشطة الاقتصادية بشكل يجعل شروط المنافسة الشريفة غير متوفرة. أخيرا وليس آخرا، ليس هناك مجال لتوسع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، عكس الشركات والمجموعات المالية والصناعية المرتبطة سياسيا، في ظل الفساد الذي ينخر مفاصل الدولة.
انطلاقا مما سبق، يتضح بأن شروط التعامل الجدي مع المسألة الاجتماعية غير متوفرة في ظل الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وما يجعل المرء غير مطمئن على المستقبل هو أن الإجراءات المعلن عنها لا توحي بالاستعداد لفتح المجال لتبني مقاربة جديدة لاشكالية النموذج التنموي. فبالإضافة إلى ما سبق تقديمه من نقد للمقاربة المعتمدة من طرف الدولة، يشكل تكليف مركز الدراسات والأبحاث التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية –وهي بمثابة ناد للدول الرأسمالية الغنية- بإعداد النموذج التنموي الجديد- مؤشرا غير مطمئن بالنظر إلى هيمنة الفكر النيولبرالي على توجهات هذه المؤسسة وانحيازها المكشوف للدفاع عن مصالح الشركات والمجموعات الاحتكارية العالمية.
إن ما ينقص المغرب هو الإرادة السياسية الواضحة للقطع مع اختيارات اقتصادية واجتماعية أبانت عن فشلها في النهوض بالاقتصاد والمجتمع وتلبية الحاجيات الأساسية للطبقات المستضعفة والفئات المتوسطة.