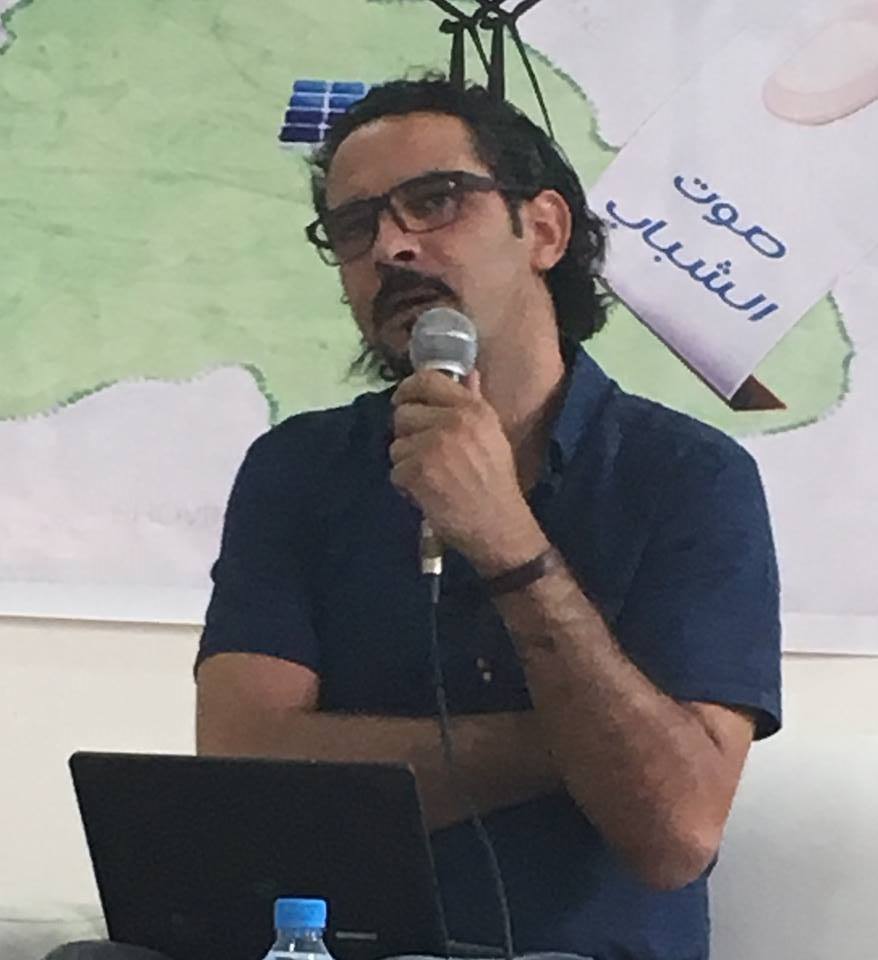يوسف الفتوحي
تعالى أنين اليأس والخذلان من حناجر و”كلافيات” الكثير من المناضلين والمتعاطفين مع فيدرالية اليسار الديمقراطي، ورسمت ابتسامة الشماتة على محيا المقاطعين، بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المغربية التي أسفرت عن احتلال حزب العدالة والتنمية للمركز الأول، والأصالة والمعاصرة للمركز الثاني. السؤال الذي يطرح نفسه بجرعة كبيرة من الاستغراب: هل كنا ننتظر غير هذا عندما صوتنا لصالح فيدرالية اليسار في ظل الشروط السياسية والقانونية الحالية؟
لنعد إلى التذكير بالبداهات كمقدمات لتفكيرنا، ما دامت سيرورة هذا التفكير أضحت تقودنا إلى نتائج مضحكة !
ينقسم الواقع العالمي اقتصاديا وسياسيا على طرفين: من جهة أولى، توجه نيوليبرالي متطرف، بما هو أيديولوجية وسياسة الرأسمال العالمي (الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، وكارتيلات البترول والأسلحة، واللاعبون الكبار في الأسواق المالية) ، والذي يُفرض ويُصرف بوساطة المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية ….) ووكلائها الصرحاء والمموهين. تتمثل أركان هذا التوجه بشكل أساسي في إلغاء جميع القيود التي من شأنها أن تقيد حركة الرساميل أو تضيق من هامش ربحها. وأهم هذه القيود التي تعمل المؤسسات المالية الدولية على تقويضها هو ما تبقى من استقلال نسبي للاقتصادات الوطنية في بعض بلدان الجنوب وأنظمة الحماية الاجتماعية فيها (الحماية الجمركية، قطاع عام قوي، استقرار قيمة العملة الوطنية، نظام ضريبي تصاعدي على الدخل، أي من يكسب أكثر يؤدي أكثر، التحكم في الأسعار وربطها بالأجور وبالتالي بالقدرة الشرائية، الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية التي تكفلها الدولة للمواطنين من أموال الضرائب والمساهمات المختلفة التي يؤدونها). وتشكل المديونية الخارجية أهم وسيلة ضغط تفرض عن طريقها المؤسسات المالية برامج ماكرو-اقتصادية نيوليبرالية، تنفذها الحكومات المحلية صاغرة مهما كانت خلفيتها الأيديولوجية (ليبرالية صريحة، اسلامية…)، لكن يبقى القاسم المشترك بينها هو لاديمقراطية أنظمتها. ومعلوم مفعول هذه السياسات على توزيع الثروات، إذ لا تفتأ تعمق الهوة أكثر فأكثر بين الفقراء والأغنياء عالميا ومحليا وتوسع رقعة الفئات المقصية والمهمشة.’ أما الطرف الثاني في هذه الثنائية فهو طيف غير متجانس من القوى والحركات المقاومة لهذا التيار النيوليبرالي الجارف، في جميع تجلياته الاقتصادية والسياسية والثقافية. قد تتولى هذه المقاومة حركات سياسية (في الأغلب الأعم يسارية)، أو اجتماعية جماهيرية، أو دولتية (العديد من دول امريكا اللاتينية). ويتأرجح ميزان القوة بين الطرفين حسب درجة المد والجزر في حركات المقاومة، غير أن قوة الرساميل تبقى إلى حدود الساعة هي الماسكة بخيوط الواقع العالمي، رغم ما تعرفه دوريا من أزمات ورغم ما تتكبده أحيانا من ضربات المقاومة، إلا أن هذا لا يعني أن الأمر يتعلق بقَدَر مغلق، بل هناك دائما حقل من الممكنات والبدائل تلوح ملامحها في الأفق بالتناسب مع درجة تنظيم وإبداع وتحالف القوى المقاومة في جبهات محلية وعالمية.
لا يشذ المغرب عن هذه اللوحة، بل هو حقل من حقول هكذا تجاذب. تشكل المؤسسة الملكية، وما يطوف في فلكها من لوبيات نفوذ وشبكات ريعية، وكيلا محليا للمؤسسات المالية الدولية ومطبقا مجتهدا لإملاءاتها، لا يحكمها في ذلك إلا اعتبارين أساسيين: هما ضمان مصالحها الخاصة إلى جانب مصالح الرأسمال المعولم، والتوجس من الانفجارات الشعبية. أما طيف الأحزاب السياسية المؤثتة للعبة السياسية الرسمية فما هو إلا “علبة أدوات” لتجديد مصداقية هذه المنظومة، و”قفازات” لتنفيذ “الأعمال القذرة”، أي السياسات النيوليبرالية المضرة للغالبية الساحقة من الساكنة، فضلا على أن النخب الحزبية نفسها تشكل جزءا من شبكات النفوذ والمصالح الريعية المحيطة بالقصر. من هنا يتبين جليا أن الفرق بين الأحزاب السياسية التي تعتلي دوريا سدة الحكومة (وليس الحكم)، هو بالضبط الفرق في درجة “جرأتها”، أو قل وقاحتها، في إنزال تلك البرامج التي تبلوَر جيلها الأول في خطط التقويم الهيكلي 1983، وجيلها الثاني في “تقرير البنك الدولي 1995” وما تلاه. من هنا نفهم أن حزب العدالة والتنمية كان هو التشكيل السياسي الأكثر تفوقا من حيث قدرته على تمرير الحلقات المتبقية من هذه البرامج النيوليبرالية (المسماة إصلاحات)، والتي لم تستطع حتى “الأحزاب الليبرالية الصريحة” أو تلك التابعة بشكل مباشر للقصر تمريرها (تحرير الأسعار ورفع الدعم، التسريع بإفلاس التعليم العمومي المجاني، ضرب الحماية الاجتماعية من خلال “إصلاح نظام التقاعد”، لجم الحريات النقابية وخصوصا الإضراب، تحرير قيمة الدرهم…..)، فضلا عن سكوته بل ودعمه الموضوعي للفساد: أي لاقتصاد الريع بمعناه الشمولي، وللاستبداد: أي لجم الحرية بجميع معانيها (تمرير قانون الوصول إلى المعلومة، محاكمة الصحافيين …)، خصوصا وهو يغلف خطابه بهالة دينية، ويوجد على رأسه زعيم شعبوي.
من هنا نقرأ نتائج الانتخابات البرلمانية وفق تخمينين ممكنين: إما أن حزب العدالة والتنمية وأمينه العام منحا ولاية ثانية، كنتيجة منطقية لكفاءتهما في لعب الدور المنوط بهما، فتكون بذلك مسيرة الدار البيضاء مجرد حركة كاريكاتورية أريد لها أن تجدد التعاطف مع بنكيران وحزبه. وإما أن العدالة والتنمية واعتمادا على قاعدته الثابتة، وعلى نسبة المقاطعة المرتفعة، وبالرغم من كل محاولات النظام، عبر درعه الحزبي (الأصالة والمعاصرة)، وبالرغم من قمع مسيرة الرباط، قد نال هذه المرتبة، وخيب آمال المخزن المرتاب من أي مكون سياسي بلغ حجما أكبر من الحجم المسموح له به، خاصة أن العدالة والتنمية ينازع الملَكية مرتكزها الأيديولوجي الذي هو الدين، ويتوجس من احتلال تابعيه لأجهزة الإدارة، استحضارا للدروس التاريخية التي مفادها أن الإسلاميين حين يعتلون سدة السلطة وينغرسون في دواليب الإدارة يتشبتون بالمخالب والأنياب. في كلتا الحالتين فالمنطق واحد والنتيجة واحدة، والحظوظ الانتخابية لفيدرالية اليسار هي نفسها.
في مقابل هذا النسق لا توجد في المغرب قوة مقاومة قادرة على تعديل موازين القوى، وبالتالي كبح سيرورة التقويض النيوليبرالي هذه، بل توجد بذور مقاومة كامنة، مشتتة وضعيفة، ومفتقرة إلى الانغراس الشعبي، موزعة بين تيارات وأفراد ناشطين في التشكيلات اليسارية الموجودة على هامش اللعبة السياسية الرسمية، ومناضلين نقابيين وجمعويين في الغالب خارج مواقع القيادة، ومثقفين وفنانين فرادى، وطاقة شبيبية كبيرة لكن كامنة تتمظهر بين الفينة والأخرى، خصوصا في التعبيرات الفنية والثقافية الهامشية.
شكلت حركة 20 فبراير مناسبة اسثنائية لتلاقي بذور المقاومة الكامنة هذه. ورغم أن الحراك آل إلى الخمود إلا انه أحدث رجة – قد تكون غير مرئية بشكل سافر- في وعي هذه المكونات وأمدها بجرعة من الأمل والثقة في قدراتها على الفعل. هذا ما يفسر التفاف جزء كبير من المثقفين والفنانين والشباب حول فيدرالية اليسار الديمقراطي في حملتها الانتخابية الحالية. ليس لأن الفيدرالية تشكل المنقد والمخلص، فهي لا تعدو أن تكون تشكيلا تنظيميا عرضيا ولا يعدم أن يتواجد الانتهازيون من داخله، وليس رهانا على صعودها إلى الحكومة وتغيير الوضع من داخل النسق فكلا الأمرين وهم خالص، وإنما لأن الأمر يتعلق بفرصة أخرى لتجميع القوى المقاومة واختبار خطابها في تواصل مباشر مع الساكنة خلال الحملة، والصدح كخطاب محرج وفاضح للنسق من داخل البرلمان إذا قيض لمرشحي الفيدرالية ولوجه، وقد ولجه الآن اثنان من مرشحيها. إنها مجرد محطة من المحطات وجبهة من الجبهات، ليست بأي حال من الأحوال بديلا عن الرهان الأساسي، الذي هو بناء قوة مضادة مستندة إلى الشارع، ليس بمعناه الغوغائي، وإنما من خلال المساهمة في بناء أدوات المقاومة الثقافية والاجتماعية الذاتية للساكنة بدءا من الفرد، كشرط لازم لتعديل عميق لموازين القوى، وبالتالي بناء الديمقراطية، وإحلال العدالة الاجتماعية، وغرس الكرامة في وعي المواطنين الأفراد قبل فرضها كغاية لسياسة الدولة.
من كل هذا يبدو الجدال بين المناضلين اليساريين، حول صواب أو خطأ موقفي المشاركة أو المقاطعة قبل 7 أكتوبر جدالا عقيما، وتحسر البعض وتشف البعض الآخر، بعد إعلان النتائج، هذر عبثي. إن الأهم بالنسبة للجميع مشاركين ومقاطعين هو، في نظري، أن نكون على وعي برهان المقاومة، وتكون الممارسة والخطاب خادمين لهذا الرهان ومؤطرين بهذا الوعي، سواء من داخل أو من خارج البرلمان.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…