حاوره: محمد الخضيري
يكتب محمد حمودان الشعر والرواية ويعبر بالنصوص مترجِما ما بين ضفتي العربية والفرنسية. الكاتب المغربي الفرنسي يقدم في ديوانه الأخير حالة طوارئ رحلة تمتد منذ العصور الإسلامية السحيقة إلى ضواحي فرنسا. ديوان متعدد الأصوات، ويكشف فيما يشبه هذيان العرافة، مشاهد من صراعات الحكم في العصور الأولى للإسلام إلى التطرف الحالي. لا يتردد الديوان في إطلاق النار على هذا الواقع المتردي، لكنه في الآن ذاته حمّال أوجه. ويؤكد مرة أخرى على أصالة وعمق صوت الشاعر، وقدرته الكبيرة على استعارة الواقع لبناء قصيدة تتجاوزه، وتجعل من الأفق الإبداعي غايته القصوى.
– “حالة طوارئ”، هو عنوان ديوانك الشعري الأّخير. ألا ترى أن عنوانا شبيها، هو بمثابة إعلان حالة طوارئ شعرية، تتماهى فيها بالواقع وبحالة الطوارئ التي تعيشها فرنسا منذ أحداث شارلي إيبدو؟
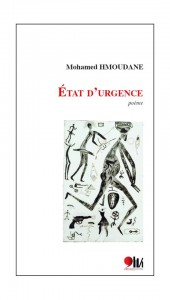 قد يكون الأمر كذلك، إذ على جميع حواس الشاعر أن تكون في حالة يقظة دائمة حتى تتمكن في أي لحظة من التقاط تفاصيل ما يدور حولها ثم إعادة صياغته في قالب جمالي. حتى وإن كان الديوان يستلهم مادته من حركية الواقع، فالشعر هنا، لا يتماهى مع هذا الواقع بقدر ما يعطيه أبعادا أخرى، وذلك من خلال ربط الحاضر، الآن والْهُنا، بوقائع تاريخية تضفي عليها القصيدة صبغة تراجيدية وملحمية بالمعنى الإغريقي للكلمة.
قد يكون الأمر كذلك، إذ على جميع حواس الشاعر أن تكون في حالة يقظة دائمة حتى تتمكن في أي لحظة من التقاط تفاصيل ما يدور حولها ثم إعادة صياغته في قالب جمالي. حتى وإن كان الديوان يستلهم مادته من حركية الواقع، فالشعر هنا، لا يتماهى مع هذا الواقع بقدر ما يعطيه أبعادا أخرى، وذلك من خلال ربط الحاضر، الآن والْهُنا، بوقائع تاريخية تضفي عليها القصيدة صبغة تراجيدية وملحمية بالمعنى الإغريقي للكلمة.
القصيدة تسرد رحلة شاسعة بين تخوم العقل والظلمات والنور على لسان ذاتٍ نجت للتو من هجوم إرهابي؛ ذات مهلوسة مثخنة بالجراح، تسرد وهي ترقص مع الجثث المتناثرة على الرصيف المليء بخراطيش الرصاص والأشلاء الآدمية، كما لو أنها امتثلت لرغبة تلك الشهرزاد المتشردة، التي وجدتها فجأة هذه الذات الشاعرة بين أحضانها وهي تحتضر وتدعوها، من خلال قلب واضح للأدوار، أن تحكي احتجازها واغتصابها وتشردها وجنونها واستحالة الحلم، الذي قُصَّت أجنحته، إلى كابوس مرعب على امتداد هذه الرقعة التي تسمى العالم العربي…
– تماما فنص الديوان يمر، من الضاحية الفرنسية إلى عصر الفتوحات. يتحدث عن صلصة الكباب المعروفة في محلات الكباب الفرنسية بالساموراي كما عن مقاتلي التنظيمات المتطرفة. يذهب ويعود في التاريخ. هل هي قراءتك الخاصة لما يشهده العالم الآن؟
من وجهة نظري، لا يمكن فهم ما يحدث في حاضرنا إذا لم نعد إلى الوراء، فالحاضر هو بالضرورة نتاج سيرورة معينة ومسلسل ذي حلقات مترابطة على الرغم من أننا قد نلاحظ استثنائيا حدوث قطيعة وقفزة نوعية في تطور هذا المسلسل. ما تعيشه المجتمعات العربية ـــ الإسلامية اليوم، مثلا، لم يأت من العدم، بل عبر تضافر مجموعة من العوامل التاريخية.
من الناحية الفنية الصرفة، كان التحدي الذي طرحته على نفسي، هو اختزال ما يناهز خمسة عشر قرنا في ثلاث وأربعين صفحة، وجعل القارئ يسافر، أثناء ربع ساعة بالكاد، دون أن يشعر بتعاقب الأزمنة، من الضاحية الباريسية إلى مكة القرن السابع الميلادي ثم العودة إلى نفس الضاحية، مرورا ببغداد، قرطبة، دمشق، سامراء بعد أن يكون قد عاش اكتمال الرسالة النبوية وتأسيس الدولة وما تلا ذلك من صراعات دموية بين “إخوة الإيمان” وثورات كثورة القرامطة والزنج… هذا من جهة، أما من جهة أخرى فقد كان علي أن أبني قصيدة متعددة الأصوات، كما لو أن الأمر يتعلق بعرض كورالي، أن أخلق “أنا” متعدد، دون أن يلتفت المتلقي إلى ذلك. فهذا “الأنا”، هذه الذات “المهلوسة” تتقمص تارة شخصية النبي وتارة أخرى شخصية متمردة بل إنها تعبر أحيانا عن وجهة النظر “الطوباوية الدموية” التي تدعو أدبياتها وفقهها إلى “نهاية العالم” ويمضي أصحابها في العمل على تطبيقها، لكن دونما إضفاء أي شرعية على همجيتها وتعطشها للدماء، بل على العكس لإظهار مدى تصلب وتخلف خطابها وفظاعة إجرامها…
وأنا أتابع دوامة العنف الذي يحصد آلاف الأرواح البريئة يوميا، في حروب عبثية يدفع ثمنها في غالب الأحيان الفقراء، حروب تشبه حروب العرب القديمة، حرب داحس والغبراء، موقعة الجمل، معركة صفين، حروب الشيعة والسنة… بدا لي كما لو أن التاريخ يعيد نفسه وهو يسطر ملاحمه بشلالات أكثر غزارة من الدماء: صراع من أجل السلطة يلبسونه قناع الدين، ويفتون بوجوب “الجهاد والشهادة”، مستعينين بجحافل من الفقهاء “الشرعيين ” ، هؤلاء الذين أسميهم “نسخ ابن تيمية المتكاثرة”، الذين يستشهدون ليل نهار بالأحاديث والقرآن، ويعقدون قران الشباب المسلم مع الحور العين اللواتي ينتظرنهم في جنات عدن الهلامية، من على منابر اليوتوب والتويتر والفيسبوك أو مباشرة على فضائيات مشيخات الغاز والبترول..
– لكن قصيدتك تقدم قراءة خاصة من وجهة نظري كقارئ. ربما أنت تُدِين بشكل من الأشكال كل هذه القراءات الخاطئة للدين. وتَفْصل من خلال نصك الشعري ما بين الدين كعقيدة وشعور روحاني وما بين الظاهرة الدينية، التي استحالت إلى عنف في زمننا الراهن؟
، بمعنى أنني أعتبر أن الدين الإسلامي، شأنه شأن جميع الديانات، والتي هي حلقة في مسلسل الفكر الإنساني عموما، ظهر، بعد مخاض طويل، نتيجة شروط اجتماعية وسياسية وثقافية معينة لينقل عرب الجزيرة من حالة إلى حالة مختلفة، بغض النظر طبعا عن الجانب الروحي. لا أحد يستطيع أن ينكر أن الإسلام أحدث ثورة، أي أنه استطاع أن يبني حضارة، عبر تلاقح العرب مع شعوب وثقافات أخرى، ساهمت إلى حد كبير في تقدم البشرية إلاّ أن ما نراه راهنا من تحجر يدفعنا إلى طرح السؤال التالي: ما الذي يقدمه الإسلام اليوم لنفسه قبل أن يقدمه للآخر، للإنسانية جمعاء؟
أما عن العنف الذي يستمد “شرعيته” من الدين، أو لنقل من تأويله الخاص للنصوص الدينية، فلا يعدو أن يكون وسيلة للبلوغ إلى السلطة، لكنها سلطة ستكون لا محالة خارج التاريخ، وذلك يبدو جليا في الخطاب والإيديولوجيا التي ترتكز عليها هذه الجماعات وحتى بعض الدول التي تستمد شرعيتها من الله مباشرة.
سلطة “كهنوتية” لن تكون خارج التاريخ فحسب بل إنها أيضا سلطة قمعية ضد الفرد والشعوب، وحريتهم وكيانهم بصفة عامة. فإذا كان الإسلام، حين ظهوره، دعا، بشكل أو بآخر، إلى التحرر والانعتاق، فهؤلاء الذين يستغلونه سياسيا اليوم، ويتخذون من العنف الدموي وسيلة لبلوغ مآربهم، لن يفعلوا شيئا آخر، إذا ما تمكنوا من الوصول إلى السلطة، سوى إعادة إنتاج القهر وخنق الحريات الفردية والجماعية. لذلك كم أستغرب عندما أقرأ في أكثر من جريدة عربية بعض المقالات، خاصة تلك المتعلقة بالوضع في سوريا الغارقة في طوفان من الدماء والخراء المعتق، من وصف جماعات ذات إيديولوجيا دينية متحجرة دموية طائفية إقصائية، بالثوار! والغريب في الأمر أن من يسطر تلك المقالات مثقفون يضفون على أنفسهم في أسوأ الحالات صفة العلمانية. إنه ربما الاشتغال بالسياسة الذي قد يدفع المرء للتحالف مع الشيطان للإطاحة بالدكتاتور، علما أن شهر العسل مع “الشيطان” سريعا ما يتحول إلى عرس من الدماء يكون فيه “الشيطان” الفحلَ الذي يأتي عروسه «الديمقراطية» جدا من الدبر: محاكم تفتيش شرعية، تهم جاهزة، ردة، كفر، زنى، زندقة… أستغرب لمن يسمي “إمارة إدلب” بالأراضي المحررة… قد يدل ذلك بكل بساطة على زيف علمانيتهم وحداثتهم أو عن انفصامهم و انتهازيتهم المتجذرة حتى النخاع: اعطني كيسا محشوا بالبترودولار فأجعل لك من “جبهة النصرة” والإخوان المسلمين وذابحي الأطفال والممثلين بجثتهم ثوارا ديمقراطيين. كان البعض منهم بالأمس القريب بعثيين حتى النخاع يمجدون صدام وبشار والبعض الآخر شيوعيا يتغنى بالتقدمية والأممية، بل إن من بينهم من ألف كتبا تنتقد بشدة الفكر الديني واستحالة بناء الدولة الوطنية المدنية تحت عباءة الإسلاميين واليوم منهم من انقلبوا على أصحاب نعمهم السالفين ومنهم من تنكروا بكل بساطة لمبادئهم السابقة واستداروا جميعهم نحو بعض عواصم الخليج التي أصبحت بين عشية وضحاها مكة “المطالبين بالديمقراطية” في الوطن العربي الحبيب الذي منّ الله عليه بربيع إسلاموي تزهر فيه جماجم الشعوب…
ولما لا في آخر المطاف؟ هم أحرار، أليس كذلك، فلا الله ولا ممثلوه في الأرض يحرمون البزنس السياسي والثقافي. فالحلال بين والحرام بين، كما يقول الفقهاء.
دعني أقول لك إنني أؤمن بقوة أنه على المثقف أن يدعو للتقدم والتحرر. لا أن يتبنى، ولو ضمنيا، الطروحات الماضوية والتحالف مع أعداء الحرية والديمقراطية والأنظمة العشائرية الغارقة في رمال التخلف، تحت ذريعة محاربة الاستبداد والدكتاتورية.
وأنا أكتب “حالة طوارئ”، رافقتني جملة من الأسئلة ألخصها كالتالي: هل للإنسان العربي حاليا قابلية للديمقراطية؟ هل “العقل العربي” جاهز لاستيعاب مفاهيمها وميكانيزماتها؟ هل النخب العربية، السياسية والثقافية، تؤمن حقا بمبدأ الديمقراطية؟ هل وجب إشعال “الثورات”، بغض النظر عن كونها نابعة من رحم التناقضات الداخلية أو عن مخططات طبخت في مختبرات خارجية، لإسقاط أنظمة فاسدة ومستبدة لإحلال الفوضى أو التيوقراطية كبديل لها؟ ألا يجب على مجتمعاتنا أن تفصل نهائيا بين الدين والدولة، أن تجعل من المعتقد مسألة تهم الفرد في علاقته الحميمية مع الإله الذي اختار هو ذاته الإيمان به وأن تبعده عن إدارة الشأن العام؟ ألم تكن الفيلسوفة حنا أرندت على حق عندما كتبت: “التحالف بين مذبح الكنيسة (الدين) والعرش (السلطة) يفقد الإثنين معا مصداقيتهما”؟
إن الدرس الذي ربما علينا استخلاصه من حمامات الدم المروعة والدمار الهائل الذي نراه هو أن على الشعوب العربية ونخبها المتنورة أن تعمل جاهدة على المدى الطويل، على بناء إنسان عربي جديد، ينظر إلى تاريخه نظرة نقدية لا تحنيطية ولا تمجيدية، أن يحدث قطيعة جذرية مع الماضي حتى يتمكن من تشييد مجتمعات صلبة ومتماسكة، تؤمن بالتنوع والاختلاف . ثم إني أتساءل ألا يمكن الضغط سلميا على الأنظمة السياسية من أجل انتزاع الحقوق وإجبارها على تنفيذ الإصلاحات، في أفق دولة ديمقراطية مدنية، فالعنف يولد عنفا أشد كما أن اللجوء إلى العسكرة يخلق بالضرورة مافيات وأمراء حرب يتاجرون في الحجر والبشر، يكدسون الثروات، غير مكترثين بمطالب الشعوب بالحرية والعيش الكريم…
أعلم أن الأمور معقدة إلى حد بعيد، أن أزمة العالم العربي مركبة للغاية كما يقول العالمون بخبايا الأمور. لا شك في أن الاستعمار ومن بعده الأنظمة السياسية التي حلت محله لعبت وما زالت تلعب دورا محوريا، بتحالف مع القوى العالمية النافذة، في تكريس الأوضاع الراهنة، في تفشي التخلف والتطرف، في تشويه الإنسان العربي وتنميط عقليته وإفراغ روحه من أي حس نقدي لكن ألم يحن الوقت أن ترى هذه المجتمعات ونخبها وجهها في المرآة وأن تضع يدها على موضع الخلل وأن تدرك أنها تتحمل كذلك قسطا ليس بالهين فيما تعاني منه من أزمات؟
المشهد العربي يشبه إلى حد بعيد التراجيكوميديا. لذا وجب كتابة قصيدة تعريه، بصلصة الساموراي اللاهبة، بدل الحبر!
– لنعد إلى ظروف نشر الديوان. لقد اخترت نشر “حالة طوارئ” في المغرب، خلافا للعادة، فأنت تنشر كتبك عن دور نشر فرنسية ؟ لماذا هذه العودة إلى البلد الأم؟
لا يتعلق الأمر بعودة إلى البلد، فعلاقتي بالمغرب لم تنقطع أبدا حتى أعود إليه. اسمح لي أن أقول لك إنك عندما تعيش الهجرة تصبح مسألة البلدان أو الأوطان مسألة نسبية، يكتنفها كثير من الغموض. باختصار، يصبح بلدك أو وطنك جسدك، بلد ووطن متنقل، مع كل الموروث الذي يقبع في طياته وكل ما يصطدم به في طريقه وترحاله.
نَشْرُ الديوان في المغرب نبع من علاقة الصداقة التي تجمعني بالناشرين حميد عبو ورشيد خالص، المسؤولين عن دار النشر “الفاصلة” بطنجة، إذ أنهما طلبا مني، أثناء دردشة بيننا، أن أقترح عليهما نصا للنشر، فعرضت عليهما “حالة طوارئ” الذي ، كان سيصدر بالمناسبة في نفس الآن في فرنسا لو لم يتراجع الناشر الفرنسي في آخر لحظة. إلا أنني لا أستبعد نشره في فرنسا باتفاق طبعا مع صديقي الناشرين.
– دعنا نتحدث عن الترجمة. أنت تترجم كثيرا في السنوات الأخيرة، ونشرت أكثر من عمل، ووصلت ترجمتك لرواية “أم الربيع” لإدريس الشرايبي إلى القائمة القصيرة لجائزة الأطلس الكبير وهي من أرقى الجوائز الخاصة بالترجمة في المغرب. لماذا التحول إلى الترجمة في مسارك الأدبي؟
بدأت حكايتي مع الترجمة في سنة 2003 عندما أشرفت على ملف خُصِّص للشعر المغربي المعاصر، صدر في مجلة “بويزي” (Poésie) التي كان يديرها الشاعر الفرنسي المعروف ميشال دوغي، إذا كان علي ترجمة بعض الشعراء المغاربة وتقديمهم لشريحة من القراء الفرنسيين. بعد ذلك، انقطعت عن الترجمة حتى طلب مني ناشر فرنسي يعيش بالمغرب، سيمون هاملان المسؤول عن مكتبة ودار النشر “الأعمدة” بطنجة، ترجمة رواية “المعركة الأخيرة للكابتن نعمت” للروائي الراحل محمد لفتح التي لم يتمكن الناشر السالف الذكر من نشرها لأن ناشرا آخر اقتنى قبله حقوق الترجمة لتصدر الرواية عن دار الأمان بالرباط، ثم قمت مؤخرا بترجمة رواية “أم الربيع” للروائي الراحل إدريس الشرايبي، وكتاب “لن تعبر المضيق” للروائي والناقد المغربي الفرنسي سليم الجاي، و”مقابلة مع ليلى شهيد” بطلب من سيمون هاملان. أما من العربية إلى الفرنسية فقد ترجمت مجموعة قصصية للكاتب والصحافي المغربي نبيل دريوش، دائما بطلب من نفس الناشر، وأخيرا كتاب “خريف فرجينيا” للشاعر عبد الرحيم الخصار بطلب كذلك من ناشر كتابه بالعربية “كراس المتوحد”. وأشتغل حاليا على ترجمة رواية “التيوس” لإدريس الشرايبي نزولا عند رغبة أرملته شينا الشرايبي وبطلب من هاملان.
كما تلاحظ، فأنا كثيرا ما أقوم بالترجمة بطلب من ناشرين وأحيانا من بعض الكتاب بأنفسهم…
– أنت تترجم في الاتجاهين أي من العربية إلى الفرنسية والعكس. هل هناك اختلاف في العمل على اللغتين؟
في الواقع، أتبنى نفس الإستراتجية في الحالتين: أحاول دائما أن أظل وفيا للنص الأصلي، لبنائه وروحه وموسيقاه، لذلك فأنا أقرأ هذا النص مرارا قبل الشروع في ترجمته، حتى أتمكن من تفكيكه جيدا لإعادة تركيبه في اللغة الأخرى، بما يتناسب طبعا مع النسق الخاص لكل لغة
– وهل تفكر يوما في الكتابة بالعربية، بحكم أنك تعمل بها الآن؟
حتى إن كانت تجمعني علاقة إشكالية باللغتين، أظنني غير قادر على اللعب باللغة العربية مثلما أفعل بالفرنسية التي بدأت الكتابة بها منذ ما يزيد على الثلاثين سنة، رغم أني أكتب بالعربية بطريقة غير مباشرة عن طريق الترجمة. زد على ذلك فأنا أكتب انطلاقا من بيئة فرنسية إن صح التعبير، من داخل نسق ثقافي وفكري أصبح جزأً من هويتي، بحكم أنني أعيش في فرنسا منذ ما يناهز ثمانية وعشرين سنة وبالتالي فأنا لا أعتبر نفسي كاتبا فرنكفونيا، كما قد يصفني البعض، بل كاتبا مغربيا وفرنسيا في نفس الآن، وهذا أمر نابع من واقع مادي ملموس ومن قناعة ذاتية.
– هناك الآن حركية واسعة في نقل الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية إلى العربية لربما أكثر اتساعا من العقود السابقة. هل هي بداية المصالحة بين الكتاب باللغتين من وجهة نظرك؟ وما هي دوافعها؟
لا أظن أنه كانت هناك عداوة بين الكتاب المغاربة الذين يكتبون بالفرنسية والذين يكتبون بالعربية، إلا في بعض الحالات كما حصل عندما حاز الطاهر بنجلون على جائزة الغونكور وقد أوخذ عليه، عن حق، تكريسه لصور نمطية فلكلورية إكزوتيكية عن الشعب المغربي لإرضاء القراء الغربيين، أو مؤخرا عندما “هاجم” بنسالم حميش عبد اللطيف اللعبي. قد يتعلق الأمر غالبا بحزازات بين الأشخاص كما قد يحدث ذلك بين كتاب يبدعون بنفس اللغة. خذ مثلا محمد برادة، وهو كاتب باللغة العربية، فهو تجمعه علاقة صداقة مع الكثير من الكتاب المغاربة الذين يكتبون بالفرنسية. لا ينفي هذا بالطبع السجالات التي عرفتها وماتزال الساحة الأدبية المغربية حول الكتابة بالفرنسية، لدواعي سياسية أكثر منها أدبية. أو أحيانا بدوافع ذاتية محضة تبدو مرضية، قد يصعب فهمها، فأنا أعرف أناسا يكتبون بالعربية تحدوهم رغبة جارفة، بل يحلمون ليل نهار بالكتابة بالفرنسية ونشر كتاباتهم في دور نشر فرنسية ومع ذلك لا يتوارون، لطالما لم يتمكنوا من تحقيق “طموحهم”، عن كيل انتقادات لاذعة ومجانية، لا ترتكز على أي دليل، “للكتاب المغاربة الفرنكفونيين” قد تصل إلى حد وصفهم بالاستلاب بل بالعمالة لفرنسا. عموما، صحيح أنه ينظر إلى الكاتب المغربي بالفرنسية بعين الريبة، بذريعة أنه يكتب بلغة المستعمر السابق. لذلك، فهذا الكاتب مطالب دائما بتبرير نفسه، بل إنه أحيانا يجنح إلى إظهار نفسه “أكثر عروبية من العروبيين” وأكثر وطنية من أعتى الوطنيين، كما لو أن حال لسانه يقول:” صدقوني يا إخوتي، أنا بريء براءة الذئب من يوسف”، المسكين!
على أية حال، فأنا أومن أن المهم ليس اللغة التي يكتب بها المرء بل قيمة ما يكتبه، هل هو رديء أم يسمو إلى الأدب.
أما فيما يخص ما تسميه “حركية واسعة في نقل الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية إلى العربية“، فأنا لا أتفق معك، فهذا أمر غير صحيح، ليس هناك على حد علمي استراتيجية واضحة المعالم أو سياسة حكومية مؤسساتية تنهض بالترجمة، هناك فقط مبادرات فردية من قبل مترجمين أو من بعض الناشرين.
– طيب، ألفت روايتين. وهما معا تتحدثان عن مهاجر مغربي يصل إلى فرنسا في عز الشباب. ليصطدم بجدار الواقع. لكنك في الآن ذاته استعدت بقوة مغرب التسعينيات بكل تعقيداته السياسية والاجتماعية، في ظل قمع سياسي شهدته تلك الحقبة، واستنسخه الأفراد بما فيهم الأطفال في حياتهم اليومية. وأنت تؤلف رواية ثالثة. هل ستكون نوعا ما تتمة لهذا المشروع الروائي أم ستستكشف أفقا آخر؟
بالفعل أنا بصدد تأليف نص روائي ثالث، لكنه يخرج عن سياق الروايتين السابقتين حتى لو أن الأحداث تقع، كما في العملين السالفي الذكر، بين فرنسا والمغرب. الراوي في هذا العمل الجديد ناقد أدبي على عتبة السبعين عاما، اشتغل لمدة أربعين سنة في جريدة فرنسية، “اختار” العودة إلى المغرب ليؤلف “التحفة الأدبية” التي كان يحلم بكتابتها منذ الأزل، إلا أنه سيصطدم بأشياء لم يكن يتوقعها…
– هناك كتابات جديدة صارت حاضرة في المشهد الثقافي المغربي. هل ترى أنها تستطيع أن تعبر بما فيه الكفاية عن هذا الواقع المركب الذي كتبت عنه، وكتب عنه آخرون سابقون ومن أبناء جيلك؟
لست ناقدا أدبيا كي أجيبك بدقة عن هذا السؤال. لكن يجب، قبل إصدار أي حكم، سلبيا كان أم إيجابيا، على هذه الأعمال التي تشير إليها، أن ننتظر تراكما مهما، فالزمن وحده قادر على الفصل بينها والقول إن كانت هذه الأعمال قد نجحت في التقاط ما تسميه “الواقع المركب” والتعبير عنه من خلال روايات تمزج بين الصرامة والقيمة الفنية الراقية. ففي المغرب أو في أي بقعة أخرى، كثيرا ما يهلل لأعمال قد يصفها البعض بــ”التحف الأدبية”chefs- d’oeuvre و قد تكللها بعض المؤسسات بجوائز أدبية غير أنها لا تصمد أمام آلة الزمن الطاحنة. ختاما، دعني أقول لك إنني ألاحظ أنه في ظل الغياب شبه التام للنقد الأدبي، غالبا ما تنشر بعض الصحف والمجلات مقالات مدحية، من خلال توزيع محكم للأدوار، لرواية فلان يكتبها أصدقاؤه الروائيون فلان وفلان وفلان قبل أن يلبس هو أيضا قناع الناقد ويكتب بدوره مقالات نقدية تسمو بروايات أصدقائه إلى مصاف الروايات العالمية، وأحيانا تعهد المهمة لصحفيين تظن عندما تقرأ خربشاتهم، أنك أمام إنشاء لتلميذ في السنة الخامسة ابتدائي أو ما دون ذلك، وكل هذا في العمق قد يضر بالنص الروائي حتى ولو كان، افتراضا، نصا عميقا وجميلا، كما لا يسمح بإرساء مشهد أدبي سليم
– دعني أعود إلى السياسي. أنت لا تحب الحديث في الشأن العام. وتردد أنك فاعل في هذا الشأن العام من خلال موقعك ككاتب. هلا فسرت لي وجهة النظر هذه؟
أنا أومن بضرورة العمل السياسي، عندما ينطلق من مبادئ صلبة وقراءة ورؤية واضحة للواقع الموضوعي، كإحدى أهم آليات تغيير هذا الواقع غير أني أعتبر نفسي غير مؤهل لمثل هذا العمل، فهو عمل يتطلب طاقة جبارة وغالبا قدرة خارقة على الحربائية وأنا إنسان كسول لا أتقن تغيير اللون، كما أنني أعلم أن الانتهازية والوصولية، الشيء الذي أمقته، مرض متفش في الكثير من الأجساد السياسية. اخترت إذن الكتابة كفعل سياسي نوعا ما، بحيث إن العمل على اللغة والتنكيل بها واغتصابها وتفكيك الخطابات السائدة هو في حد ذاته فعل سياسي.
بايتاس معلقا على ندوة “البيجيدي”: لا يمكن مناقشة حصيلة حكومية لم تقدم بعد
اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق ا…





















